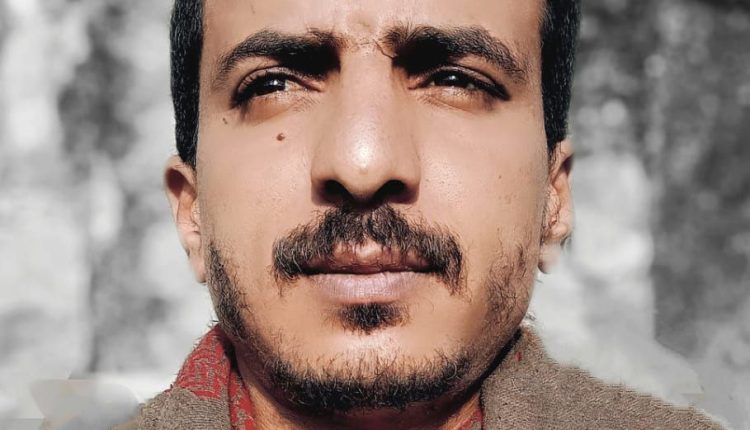من بلفور إلى “الكابيتول”.. استمرارية المشروع الصهيوني وتغلغله في قلب واشنطن
البيضاء نت | مقالات
بقلم / فهد شاكر أبوراس
بعد مرور أكثر من قرن على وعد بلفور المشؤوم، لا تزال الآلة الصهيونية تعمل بلا كلل لنسج خيوط هيمنتها على نسيج السياسة الأمريكية، حتى باتت واشنطن – في كثير من مواقفها – تُنطق بلسانِ كَيان الاحتلال، لا بلسان شعبها.
فالصورة المثالية التي تروّج لها الولايات المتحدة عن نفسها كمعقل للديمقراطية وحقوق الإنسان، تتهاوى عند أول اختبار حقيقي، حين يظهر تناقضها الأوضح: الدعم غير المشروط والمطلق لـ كَيان الاحتلال، بغض النظر عمّن يحكم – ديمقراطيًّا أكان أم جمهوريًّا، ليبراليًّا أَو محافظًا.
هذه الظاهرة ليست صدفةً عابرة، ولا نتاج تقارب قيمي مؤقت، بل هي ثمرة استثمار استراتيجي طويل الأمد، متعدد الأوجه، نفّذه مشروع استعماري استطاع أن يبني في قلب الإمبراطورية الأمريكية أقوى شبكة نفوذ سياسي في التاريخ الحديث.
إنها قصة تحولت فيها الفكرة الصهيونية من حلم ديني عند طائفة من المسيحيين الإنجيليين المتطرفين، إلى سياسة تُحدّد مسارات العالم.
ولا تعتمد هذه القصة على مؤامرة سرية خفية، بقدر ما تعكس نجاحًا مؤسّسيًّا منهجيًّا في اختراق آليات صنع القرار واحتوائها، لتوجيهها نحو خدمة أهداف لا تتوافق – في كثير من الأحيان – مع المصلحة الوطنية الأمريكية، بل وغالبًا ما تتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والإنسانية.
جذور التحالف: من لندن إلى واشنطن
ولّدت هذه العلاقة الوثيقة من رحم تحالف غير مقدس بين قوى مختلفة في الدوافع، لكنها متجانسة في الأهداف.
فبحسب المؤرخ الإسرائيلي الجريء إيلان بابيه، لم تكن الجذور الأولى للوبي الصهيوني يهودية، بل مسيحية إنجيلية بروتستانتية نبتت في بريطانيا الفيكتورية خلال القرن التاسع عشر.
هؤلاء الإنجيليون، المستندون إلى تفسير حرفي مشوّه للنبوءات الكتابية، رأوا في “عودة اليهود إلى فلسطين” تمهيدًا لمعركة “هرمجدون” ونهاية العالم.
فتحالفوا مع إمبرياليين بريطانيين رأوا في تفكيك الإمبراطورية العثمانية فرصةً استراتيجية، ومع صهاينة وجدوا في هذين الطرفين حليفًا قويًّا لتحويل حلمهم إلى واقع سياسي.
وكانت الثمرة الأولى لهذا التحالف الغريب وعد بلفور عام 1917، ذلك الخطاب القصير الذي غيّر وجه التاريخ، حين وعدت بريطانيا – دون وجه حق – بـ”وطن قومي لليهود في فلسطين”، ليس بدافع النبل الأخلاقي، بل كصفقة استراتيجية لتعزيز المصالح الإمبريالية البريطانية.
ومع أفول نجم لندن وبزوغ نجم واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية، بدأ مركز الثقل الصهيوني ينتقل عبر المحيط الأطلسي.
وكان مؤتمر بيلتمور في نيويورك عام 1942 بمثابة ولادة المشروع الصهيوني في السياق الأمريكي، حين طُرحت لأول مرة – بصراحة – مطالبة بإنشاء “كيان يهودي” في فلسطين، ممهدة الطريق للقرار الدولي المشؤوم رقم 181 عام 1947.
بناء آلة النفوذ: من الشارع إلى الكونغرس
لم يترك الصهاينة الأمر للصدفة، بل بدأوا فورًا في بناء آلة ضغط لا هوادة فيها، تحوّلت مع الزمن إلى واحدة من أقوى كيانات النفوذ في المشهد السياسي الأمريكي.
ولا تتجسد هذه الآلة في منظمة واحدة، بل في شبكة معقدة ومترابطة تشكّل نظامًا بيئيًّا كاملًا للتأثير.
في قلبها تقف منظمات مثل “أيباك” (لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية)، التي أصبح اسمها مرادفًا للوبي الإسرائيلي، لكنها ليست وحدها.
فهناك “مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى”، وربما الأهم: “المسيحيون المتحدون؛ مِن أجلِ إسرائيل”، الذي بات يُوصَف بأنه أكبر لوبي مؤيد لكَيان الاحتلال في الولايات المتحدة على الإطلاق؛ مما يكشف استمرار التحالف التاريخي بين القوى الصهيونية والمسيحية الإنجيلية.
تعمل هذه الشبكة عبر آليات دقيقة لا تخطئها العين:
التحكم في التمويل الانتخابي: فتموّل المرشحين المخلصين لـ كَيان الاحتلال، وتدمّـر – عبر حملات تشويه منظمة – كُـلّ من يجرؤ على انتقاد سياساتها.
التأثير على الخطاب العام: عبر السيطرة على وسائل الإعلام، وترويج رواية أحادية تُضفي شرعية على أفعال كَيان الاحتلال، حتى لو بلغت حَــدّ العنصرية أَو جرائم الحرب.
ففي حرب غزة الأخيرة، لم يُكتفَ بالدفاع عن القصف، بل تم ترويج فكرة تهجير سكان غزة كـ “حَلٍّ إنساني”!
النفوذ في الممارسة: من الفيتو إلى الكونغرس
هذا النفوذ لم يبقَ حبيس الكواليس، بل تجسّد في وقائع ملموسة:
استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن مرارًا كـ”درع” يحمي (إسرائيل) من أية مساءلة دولية، حتى حين يتوافق العالم بأسره على إدانتها.
خلال الحروب على غزة، وقفت الإدارات الأمريكية – ديمقراطيةً أكانت أَو جمهورية – عائقًا أمام وقف إطلاق النار؛ مما مكّن من استمرار القتل والدمار.
تتدفق مليارات الدولارات من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين سنويًّا لتمويل الجيش الإسرائيلي، لضمان تفوّقه العسكري المطلق، مما يجعل واشنطن شريكًا صامتًا في كُـلّ عدوان.
ولعلّ أبرز تجليات هذا النفوذ ما حدث عام 2015، حين تآمر رئيس مجلس النواب الجمهوري جونBoehner سِرًّا مع السفير “الإسرائيلي” في واشنطن، رون ديرمر، لتنظيم زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونغرس، هاجم فيه سياسة الرئيس أوباما في الاتّفاق النووي مع إيران، وسط تصفيق حار من النواب الأمريكيين!
كانت تلك اللحظة تجسيدًا صارخًا لولاء مزدوج: فقسم كبير من النخبة السياسية الأمريكية يدين بالولاء لـ”إسرائيل” أكثر مما يدين بولائه لرئيس بلاده.
النظام المصمم للخضوع
ورغم كُـلّ هذا، تبقى الحقيقة القاسية أن النظام الانتخابي الأمريكي، بكل زخمه الديمقراطي المعلن، يفتقر إلى الآلية الفعّالة للتحرّر من هذا النفوذ المؤسّسي.
فالمؤسّسات السياسية صُمّمت بحيث يصبح الخروج عن الإجماع المؤيد لـ (إسرائيل) انتحارًا سياسيًّا لأي مرشح طموح.
وهكذا، تتحول الانتخابات إلى طقس شكلي متكرّر، يُضفي شرعيةً على سياسات ثابتة لا تتزعزع، تخدم مصالح نخبة نافذة ومشروعًا استعماريًّا عنصريًّا، على حساب المصلحة الأمريكية نفسها، وعلى حساب شعوبٍ أُخرى تدفع الثمن من دمائها وأرضها.
في هذه الدراما السياسية التي تتكرّر كُـلّ عامين أَو أربعة، يتصارع المرشحون على من يُظهر ولاءً أكثر إطلاقا لكيان العدو، بينما يظل الشعب الفلسطيني – وحقه في الحرية والكرامة – الحلقة المفقودة، والضحية الدائمة في معادلةٍ صُمِّمت لإهدار إنسانيته، وضمان استمرار النهب باسم “الأمن” و”الديمقراطية”.