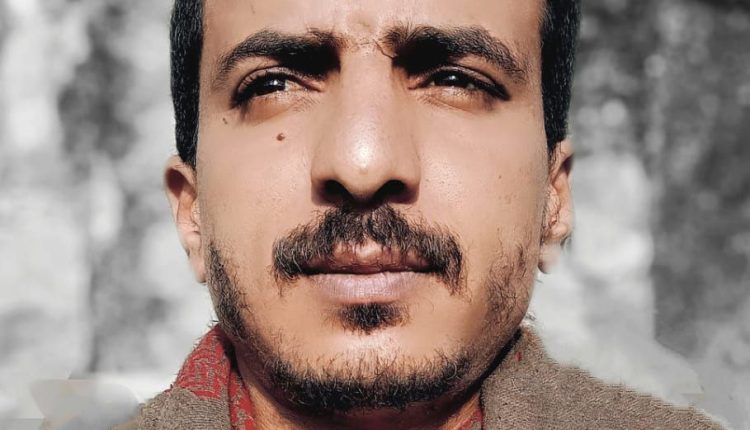أكذوبة السلام.. الاتّفاقات الصهيونية من كامب ديفيد إلى شرم الشيخ
البيضاء نت | مقالات
بقلم / فهد شاكر أبوراس
بعد أكثر من عامين من العدوان المتواصل على قطاع غزة، وفي خضم تحولات جيوسياسية عميقة تهز أركان المنطقة، يبرز ما يُسمى بـ”اتّفاق شرم الشيخ” لوقف إطلاق النار، ليس كحدثٍ منعزل، بل كحلقةٍ جديدة في سلسلةٍ طويلة من الاستراتيجية الصهيونية الثابتة في التعامل مع الاتّفاقات.
وهذه الاستراتيجية، المتجذّرة في الفكر الصهيوني التوسعي منذ بداياته، دائمًا ما تتعامل مع أي اتّفاق ليس كغايةٍ للسلام، بل كأدَاة تكتيكية مرحلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا للمشروع الصهيوني.
فمنذ نظرية “الجدار الحديدي” لجابوتنسكي، التي ترى أن إحباط الأمل العربي يتطلب عرضَ قوةٍ ساحقة لا تُقاوَم، إلى قبول بن غوريون التكتيكي لقرار التقسيم سنة 1947م كجسرٍ لاستكمال السيطرة الصهيونية على الأرض، كان الثابت الوحيد هو المرونة في الوسائل لتحقيق الأهداف الثابتة.
لقد فهمت القيادة الصهيونية مبكرًا أن بقاءها وازدهارها مشروطٌ بالاندماج الكلي في المشروع الإمبريالي الغربي، وهو ما تجلّى في الاستفادة من وعد بلفور كأدَاة استعمارية لتحقيق حلم الكيان الصهيوني.
يتضح هذا النهج جليًّا عند تتبّع مسار الاتّفاقات الرئيسية التي عقدها الكيان الصهيوني عبر تاريخه.
فاتّفاقات الهُدنة سنة 1949م مع الدول العربية لم تكن سوى وسيلةٍ لترسيخ وجود الكيان الناشئ وإضفاء شرعيةٍ دولية على واقع الاحتلال الذي فُرض بعنفٍ سابق.
ثم جاءت اتّفاقية كامب ديفيد مع مصر سنة 1978-1979م لتمثل نقلةً نوعية في هذه الاستراتيجية، حَيثُ استغل الكيان حرب أُكتوبر وحاجة النظام المصري إلى فك الارتباط بالصراع، ليس لتحقيق سلامٍ عادل، بل لكسر أكبر جيشٍ عربي وإخراج مصر من دائرة المواجهة، مما فكّك التضامن العربي وأضعف القضية الفلسطينية بشكلٍ جوهري.
ولم تكن اتّفاقات أوسلو سنة 1993م سوى فصلٍ آخر من هذا المسلسل، حَيثُ تم تحويل طبيعة الصراع -تحت وطأة الانتفاضة الأولى- من صراع وجودٍ إلى نزاعٍ على حدود، وتم إنشاء سلطةٍ فلسطينية لإدارة الشؤون اليومية للشعب الفلسطيني، بينما احتفظ الكيان بالسيطرة الأمنية والعليا على الأرض والإمْكَانيات، محولًا الصراع إلى إدارة احتلال منخفض التكلفة.
ومع دخول الألفية الجديدة، وتصاعد الهشاشة في الأنظمة العربية وتغيّر الأولويات الإقليمية، استغل الكيان هذه الظروف لدفع استراتيجيته إلى آفاقٍ جديدة.
فمبادرات التطبيع مع بعض الأنظمة العربية سنة 2020م لم تكن سوى محاولةٍ مدروسة لكسر العزلة الإقليمية المتبقية، وتجاوز القضية الفلسطينية تمامًا، لتحقيق التطبيع الكامل قبل إنهاء الاحتلال؛ مما يفرض واقعًا جديدًا يجعل من الحقوق الفلسطينية قضيةً هامشية.
وهذا النمط من التعامل مع الاتّفاقات يتكيف دائمًا مع طبيعة الخصم والسياق؛ فمع الدول العربية يسعى لإخراجها من دائرة الصراع وكسر الحصار الإقليمي.
وفي كُـلّ الأحوال، يتم تفسير أي اتّفاق عبر منظور “الأمن القومي” الضيّق، حَيثُ تُستخدم الدبلوماسية والقوة الاقتصادية ليس للتوصل إلى حلولٍ عادلة، بل لخدمة الردع العسكري والحفاظ على التفوق الاستراتيجي المطلق.
إنه استغلال منهجي للانقسامات العربية والهشاشة الإقليمية لفرض وقائع جديدة، واختراق الخطوط الحمراء واحدةً تلو الأُخرى دون تكبّد كلفةٍ تُذكر.
وفي هذا الإطار، يأتي “اتّفاق شرم الشيخ” لوقف العدوان على غزة ليمثل امتدادًا طبيعيًّا وصارخًا لهذه الاستراتيجية التاريخية.
فهو ليس اتّفاقًا ينبثق من رغبةٍ في تحقيق سلامٍ دائم، بل هو تكتيكٌ مرحلي أُجبر الكيان عليه جراء صلابة المقاومة وصمود الشعب الغزّي، وتصاعد الضغط الدولي، ودخول القضية الفلسطينية مرحلةً جديدة من التداول العالمي بعد سنواتٍ من التهميش.
لقد جاء الاتّفاق في سياقٍ ميداني وإقليمي معقَّد، حَيثُ يسعى الكيان إلى تحويل نفسه إلى شريكٍ استراتيجي في مواجهة تحالفاتٍ إقليمية ناشئة، ويبحث عن متنفسٍ لمواجهة التحديات الأوسع، خَاصَّة مع إيران واليمن.
فالأهداف الإسرائيلية من هذا الاتّفاق واضحةٌ وجزئية: تحقيق “نصرٍ إعلامي” على الساحة الداخلية من خلال استعادة بعض الأسرى -وهو هاجسٌ للقيادة السياسية التي تواجه أزمة شرعيةٍ عميقة- كما تسعى إلى كسر دائرة الضغط العسكري المُستمرّة التي استنزفت قواها وأظهرت حدود قوتها، وإعادة ترتيب الأوراق استعدادًا لجولات صراعٍ مقبلة.
والأهم من ذلك أن هذا الاتّفاق يكرّس منطق “إدارة الصراع” لا حله، فبنوده التي تركز على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة الإنسانية، تتجاهل عمدًا المعالجة الجذرية للأسباب الكامنة وراء اندلاع العدوان، مثل إنهاء الحصار الخانق المفروض على غزة المُستمرّ منذ سنوات، ووقف الاستيطان، وضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وإقامة دولته.
وبالتالي، يتحول هذا الاتّفاق إلى مُجَـرّد “هدنةٍ” هشة قابلةٍ للانفجار في أي لحظة، تمنح الكيان الوقت الكافي لإعادة تجميع صفوفه وإعادة بناء قوته الردعية، بينما يبقى الوضع الأَسَاسي للاحتلال والقمع على حاله.
وهذا يؤكّـد بقوة أن الكيان لا يزال يتعامل مع الاتّفاقات كأدَاة تكتيكية في صندوق أدواته، وليس كمسارٍ حتمي نحو سلامٍ عادلٍ وشامل.
فهو يستخدم الدبلوماسية لتحقيق مكاسب مرحلية فورية، مثل إعادة الأسرى وتخفيف الضغط الدولي، مع الحفاظ -بشكلٍ حذر- على حرية العمل العسكري والأمني في المستقبل، تمامًا كما كان الحال في العديد من الاتّفاقات السابقة التي لم تمنع أبدًا استمرار الاستيطان وعمليات القتل اليومية.
ولذلك، فإن خلاصة هذه السردية الطويلة تؤكّـد أن التعامل الصهيوني مع الاتّفاقات هو تجسيدٌ عملي للأيديولوجيا الصهيونية التي تضع الهدف فوق الوسيلة، وتستخدم المفاوضات كأدوارٍ مرحلية لتحقيق مكاسب تراكمية يصعب التراجع عنها.
إنه نهجٌ يعتمد على قراءةٍ دائمة لميزان القوى المحلي والإقليمي والدولي؛ مِن أجلِ ضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة مع الحفاظ على السيطرة وفرض الأمر الواقع.
وفي ضوء ذلك، يبدو اتّفاق وقف العدوان على غزة مُجَـرّد استراحةٍ استراتيجية لإعادة التجييش وترتيب الأولويات، أكثر منه بدايةً لحلٍّ دائمٍ يضمن الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
إنه يذكرنا بأن العدالة الحقيقية والتحرّر لا يمكن أن يتحقّقا من خلال اتّفاقياتٍ مصممةٍ للحفاظ على هيكل القوة القائم، بل فقط من خلال استمرار المقاومة بكل أشكالها، وصمود الشعب، وكسر منطق القوة الذي يفرضه المحتلّ.
فالتاريخ يثبت أن الحقوق تُنتزع ولا تُوهب، وأن أي اتّفاق لا يرتكز على العدالة وإنهاء الاحتلال هو مُجَـرّد هدنةٍ مؤقتة في صراعٍ طويل لن ينتهي إلا بتحقيق الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني.